الحسين بوخرطة
قد يتساءل القارئ عن اختيار كلمات عنوان هذا المقال، ليكون جوابي كون “عبارة الخصوصية الاتحادية في صلب الخصوصية المغربية” كانت العبارة الأساس الدافع، الذي جعلني أقرر الانتماء لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مرحلة العمر اليافعة (مرحلة شباب وشموخ ورفعة الإنسان). لقد اعتبرت بإيمان شديد أن استراتيجية الانتقال الديمقراطي، التي اعتنقها الحزب سنة 1975، هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله التكيف مع واقع المغاربة، والتفاعل معهم بقوة، بآليات الإقناع والاقتناع، في أفق إيصالهم إلى مراحل متقدمة من الوعي السياسي والثقافي، وعي يجعلهم يربطون، بإيمان راسخ، بين الاختيار الانتخابي والقيمة الفكرية والمعرفية للنخب، وخبرتهم وتجربتهم النظرية والميدانية، ومسؤولياتهم الإنسانية، وشفافية تاريخهم النضالي وغناه بالقيم الحقوقية والأحداث المدافعة عن حق المغاربة في بلد متقدم ديمقراطيا وحقوقيا واقتصاديا وثقافيا.
وهنا، وباستحضار التاريخ السياسي المغربي، قبل وخلال وبعد الاستقلال، ومصلحة الشعب المغربي وحقه في بناء دولة قوية وموحدة وديمقراطية ذات سيادة واعتراف سياسيين قويين كونيا، لا يمكن للمتتبعين، في اعتقادي، إلا أن يقروا بأن الاتحاد قد اختار الأسلوب الصعب والممكن والشرعي والملائم في نفس الوقت في ظرفية عالمية صعبة ومعقدة للغاية. إن الحرص على الحفاظ على التواجد الحزبي في الثقافة السياسية للمغاربة كاستراتيجية من خلال النضال الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية، وتحسين موقعه الانتخابي وتأثيره المؤسساتي باستمرار، وبنفس وطني صادق، وتمكين الوطن من التطور من خلال قيادة سياسية للتغيير تكون متميزة بحكتها وتبصرها، لا يمكن أن يتجسد في حياة الشعب المغربي إلا من خلال التفاعل اليومي القوي بين الفكر والواقع، بالشكل الذي يضمن يوميا تطور مقومات القيادة المعرفية للأوضاع، وبالتالي تحويل التراكمات إلى مضادات حيوية قارة ضد العراقيل الواقعية والمفتعلة، وحماية مسار بناء الدولة القوية التي يستحقها الشعب المغربي.
وبذلك، تكون إرهاصات تغليب كفة الوهن والتعب والمسايرة بتفويت التمثيلية السياسية لنخب خارج أسس وأهداف ومرامي استراتيجية الانتقال الديمقراطي ارتخاء سياسيا، لا يجب السماح له بالتجذر حزبيا خارج الروح الجماعية الاتحادية ونواته الصلبة الضامنة لوجوده التاريخي. فنجاح مراكز المسؤولية في الدولة بكل مكوناتها بشكل عام في قيادة التغيير بخطى ثابتة، لا يمكن أن يتحول إلى واقع ملموس تستشفه يوميا نفوس المغاربة إلا في حالة اختيارها على أساس الكفاءة والإنسانية والمعرفة ونقاوة اليد.
إن نجاعة فعل ومردودية الممارسين، تحت إشراف النخب القيادية مؤسساتيا، قد تتحول بشكل فوري إلى حبر على ورق بقيمة معرفية واضحة وبتفعيل ضعيف للغاية بمجرد ما يتم تنصيب القيادات المهووسة بالاغتناء، والتي تميل إلى اعتبار كون تشكيل فرق القيادة لا يتأتى إلا من خلال آلية الموالاة، التي يتم التعبير عنها برسائل واضحة للطامحين في الريع والاسترزاق، وتوسيع الهوامش التي تمكنهم من الاستفادة ماليا خارج أعراف الاستحقاق والمساواة. بهذا الأسلوب، الذي يزرع التذمر وعدم الثقة في المؤسسات، يتحول العمل الجاد، والكفاءة السامية، والمسؤولية الإنسانية، إلى عدو منبوذ في أوساط الموارد البشرية في التنظيمات العمومية والخاصة والمجتمعية. أما في الحالة المعاكسة، عندما يتم إقرار القيادة القوية، نظريا وواقعيا، على الأسس المتعارف عليها في علوم التدبير، تتحقق الأهداف النبيلة. بالطبع، هذا السبيل مشوب بالصعوبات، ويتطلب عملا ذكيا للغاية، ومتواصلا في الزمن، ويكون مداه متوسطا وبعيدا، لكنه يمكن، لا محالة، وكما عبرت التجارب المؤسساتية عن ذلك، من تحقيق نتائج مبهرة. لقد تتبعنا، في عدة مؤسسات وطنية، كيف تم تحريرها من سيطرة لوبيات الريع والفساد، وتم إعلان مرورها إلى مراحل متقدمة في الإصلاح، مراحل فتحت المجال على مصراعيه للنخب الجادة الكفيلة بضمان ديمومة الأداء الوطني البناء.
أكتفي بهذا القدر، لأقول للقارئ، إن التاريخ البشري عامة، والمغربي خاصة، قد عبر بجلاء كون ملامسة مقومات الوجود البشري وجودتها، بالنسبة للفاعل المؤسساتي حزبيا وسياسيا وإداريا، لا تكتسب القيمة الوجودية التاريخية المطلوبة إلا من خلال الالتزام بجودة الفعل الدائم، الذي يستمد أنماط تدبيره الاستراتيجي من المعرفة والفكر والخبرة والتجربة والنزاهة والوعي بالواقع والسعي لتغييره من خلال محطات زمنية واضحة، تضفي الشرعية السياسية على القيادات وهي تقدم الحصائل من فترة لأخرى.









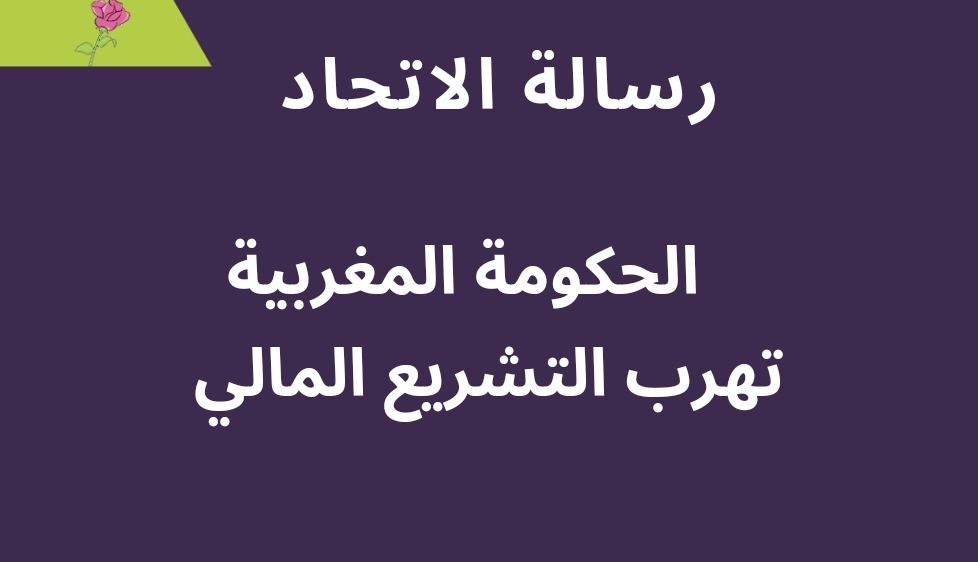
تعليقات الزوار ( 0 )