ليس هذا حكما مسبقا وليس تجنيا أو افتراءا على رئيس الحكومة؛ كما أنه ليس شتيمة أو قذفا في حقه؛ بل هو مجرد تسجيل لواقع، تؤكده كل تصرفات وأقوال الرجل. لا نحتاج إلى تأويل كلامه لتقويله أشياء يستحق عليها عدم الاحترام. فهو الذي لا يحترم وضعه المؤسسي والبروتوكولي (الرجل الثاني في الدولة)، حين يركب البذاءة والسفاهة والوقاحة والرداءة والضحالة…بكل تجلياتها، في مواجهة خصومه السياسيين، سواء داخل مؤسسات الدولة (البرلمان كمثال) أوفي خطبه بالساحات العمومية ( التجمعات الحزبية والنقابية). ومن كان هذا هو ديدنه، فكيف يمكن احترامه؟ ذلك أن الاحترام يُستحق؛ وهو ليس سهل المنال.
ويدو لي مفيدا تقديم مفهوم للاحترام، رغم شيوع هذه الكلمة وذيوع معناها، علَّني أبرز للقارئ، وبالأخص المتعاطف مع «بنكيران»، الاعتبارات التي جعلتني أرى أن رئيس حكومتنا غير جدير بالاحترام؛ وبالتالي غير أهل بالمسؤولية التي بوأته إياه صناديق الاقتراع ومقتضيات الدستور الجديد. لقد أثبت، وبالملموس، أنه لا يستحق المسؤولية التي يتحملها. فهو دونها (أو هي أكبر منه) بكثير. ولذلك، لم يرق بسلوكه، أبدا، إلى مستوى المؤسسة التي يرأسها. هذا، دون أن نقارنه بالقامات (أو الهامات) الكبيرة من عيار المجاهد «عبد الرحمان اليوسفي».
أعتقد أن كل تعاريف كلمة الاحترام تتفق على أنه قيمة أخلاقية يتميز بها الإنسان. غير أن هذا لا يعني أن كل إنسان يقدر هذه القيمة الأخلاقية. فليس كل إنسان يكن الاحترام لغيره أو يستحق الاحترام من غيره؛ بل ينقسم الناس إلى صنفين: صنف لا حظ له في الاحترام، وصنف جدير بالاحترام.
وتجدر الإشارة إلى أن للشخص دورا كبيرا في الاحترام الذي يحظى (أو لا يحظى) به. فكم من مرة يُواجه، في الاجتماعات، حين يشتد النقاش، كل من يتجاوز حدود اللياقة وشروط الحوار، بعبارة «احترم نفسك». وهي عبارة تحمل تهديدا واضحا بالمعاملة بالمثل؛ أي عدم الاحترام. وأتذكر، هنا، حكاية تروى حول الوالي الصالح «عبد الرحمان المجدوب» الذي مازح، يوما، أطفالا كانوا يلعبون بإحدى الساحات، فأساءوا معه الأدب، فقال قولته الشهيرة: كنت أعتقد أن الناس يحترمونني؛ فإذا بي أنا الذي أحترم نفسي.
والاحترام (أو التقدير)، مبعثه الهَيْبة في النفس. وهو ليس مسألة إرادية؛ فأنت لا تقرر أن تحترم هذا ولا تحترم ذاك؛ بل، تقدر أن هذا يستحق احترامك وذاك لا يستحقه، بغض النظر عن اختلافك أو اتفاقك معه في الرأي. وهذا التقدير لا ينبني على رغبة شخصية أو نزوة ذاتية؛ بل هو استحقاق، تتداخل فيه عوامل متعددة، منها ما هو ذاتي وما هو موضوعي. وغالبا ما نشعر بالاحترام تجاه من تتطابق أقواله مع أفعاله. وفي ذلك دليل على صدقه ومصداقيته واستقامته. وهو ما يمكن التعبير عنه بحسن الخلق.
وحسن الخُلُق يعني امتلاك صفات حميدة تنعكس في تصرفات وسلوك الشخص. فالذي يشتم، مثلا، خصومه فهو غير حَسنَ الأخلاق؛ والذي يخدع الناس ويكذب عليهم أو يمارس عليهم الدجل، لن يكون أبدا من أصحاب الأخلاق الحميدة؛ والذي يتصنَّع الطيبوبة لن يكون طيبا؛ والذي يدعي المظلومية، ليس إلا مخادعا ومواربا…الخ. بالمقابل، كل شخص يتمتع باحترام الناس، فهذا دليل على حسن خلقه.
هناك شعور يقترب كثيرا من الاحترام وهو الإعجاب. غير أن الفرق بينهما كبير. فالإعجاب ينتج عن الانفعال والدهشة؛ بينما الاحترام هو قيمة أخلاقية تنبع من الهيبة في النفس، كما أسلفنا.
لا شك أن لـ»بنكيران» معجبين ومحبين. فمنهم من يحب فيه بذاءة خطابه؛ ومنهم من يعجب بوقاحته (فأن يقره، بالتصفيق والصراخ، فريق حزبه ونواب من الأغلبية على استعمال كلمة سفهاء في حق نواب الأمة، لهو دليل على الإعجاب بالوقاحة)؛ ومنهم من ينبهر بكلامه السوقي؛ ومنهم من يمجد شعبويته… وقد يكون من بين هؤلاء وأولئك من هم، سياسيا وإيديولوجيا وفكريا وثقافيا، على النقيض تماما.
وهذا ما ينطبق على القيادي اليساري «الجذري» الأستاذ «محمد الساسي». لقد أبهرته خطابات «بنكيران» ونالت إعجابه، فخصص لها مقاله الأسبوعي بجريدة «المساء» ليوم الخميس 23 أبريل 2015. ويطفح من هذا المقال الكثير من الإعجاب بخطابات «بنكيران». وإذا كان مفهوما أن يحفل الموقع الإليكتروني للحزب الأغلبي بهذا المقال، لما فيه من إعجاب بزعيم هذا الحزب، فإننا نكاد لا نميز، فيه، بين أسلوب أستاذ العلوم السياسية والقيادي السياسي الحداثي وأسلوب «تلفيق بوشرين» الذي تحول إلى بوق في خدمة «بنكيران» وحزبه.
وإذا كان هذا الأسلوب يبعث على الاستغراب، فإننا نعتقد أن موقف «الساسي» من خطابات «بنكيران»، يتحكم فيه عاملان ذاتيان أساسيان: العامل الأول هو الإعجاب الذي قلنا عنه بأنه انفعال؛ وبالتالي، فهو لا يعتد به علميا (يبدو «الساسي»، في هذا المقال، متجردا عن وظيفته العلمية وعن هويته السياسية)؛ أما العامل الثاني، فيتمثل في العقدة المستحكمة بقادة ما يسمى باليسار الجذري تجاه ما يسميه «الساسي» نفسه اليسار التقليدي؛ ويقصد به الاتحاد الاشتراكي(الذي تربى في أحضانه وتلقى تنشئته السياسية في صفوفه).
لن أنطرق الآن إلى ما جاء في ذلك المقال من كلام فاقد للموضوعية، حتى لا أخرج عن الموضوع الذي أردت طرحه في هذه السطور (لكني أعد القارئ بالعودة إليه مستقبلا)، وهو جدارة الاحترام من عدمها.
لا بد من التذكير بأن الاحترام (مثله مثل الثقة، بل وحتى الإيمان) يزيد وينقص حسب الظروف والعوامل المحيطة بعُنصُريْه؛ ونقصد بهما الشخص المحترَم والشخص المحترِم. فقد تنعدم شروط استمرار الاحترام لسبب من الأسباب، فتنقلب المعادلة. وهذا يحدث كثيرا في العلاقات الإنسانية. أما في المجال السياسي، فحدث ولا حرج.
وعندما تنقلب المعادلة، فقد تصل الأمور إلى عكسها، فيصبح الازدراء والاحتقار سيد الموقف، خاصة إذا كان طرفا هذه المعادلة أو أحدهما من أصحاب العقول الصغيرة (أي البسيطة) والقلوب الباغضة والحقودة.
خلاصة القول، ما يؤرقني، في الواقع، كمواطن وكفاعل سياسي ليس هو عدم جدارة رئيس الحكومة بالاحترام في حد ذاته؛ بل هو المجهول الذي يقود إليه البلاد (وقد لا يكون ذلك عن جهل!) سياسيا واقتصاديا واجتماعيا… مع الإصرار على القرارات التي تعمق الفوارق الاجتماعية وتوسع هوامش الهشاشة بتقليص الطبقة المتوسطة وتضرب في العمق المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية…؛ الشيء الذي يوحي بوجود مشروع خطير، يعمل على تبخيس العمل السياسي وتهجينه (خطابا وأسلوبا وممارسة) بهدف توسيع دائرة العزوف عن الانتخابات حتى يتسنى للحزب المتأسلم الهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع ليعود بنا إلى عهد الاستبداد المقيت.









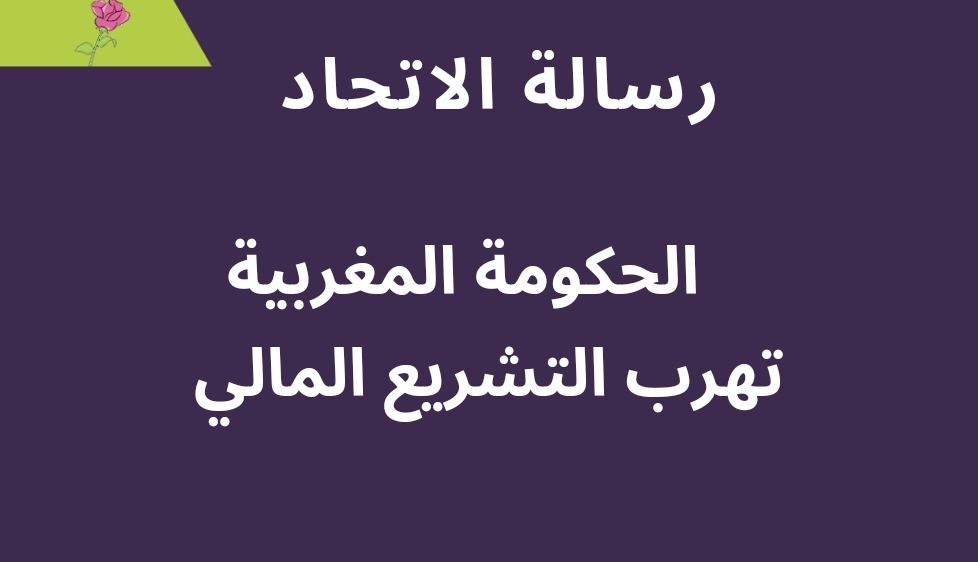
تعليقات الزوار ( 0 )