ذ بنسالم حِـمِّيش
لم أجالس السيد نور الدين عيوش إلا مرة واحدة ومصادفةً، وكانت ببيت الراحل عبد الجبار السحيمي في ذكرى وفاته. رأيته يتنقل من طاولة إلى أخرى، لا يفتر عن التلويح والكلام. ولما أقبل على طاولة كنت من بين جلسائها، اقتعد كرسيا وواجه السيد عبد الواحد الراضي بكلام فظ مفاده بالعربية: كنت قدمت خطة إصلاح ولم تعمل بها، وها إن حزبك الان يغرق… وحين عاد صاحب المقعد السيد خالد الناصري اضطر المستولي عليه إلى مغادرته مكرها، وظل الراضي غير آبه لوقاحة المنسحب النّزق…
كنت أسمع عن عيوش أنه “رجل نفوذ” وصاحب مبادرات، منها “القروض الصغرى” و”الديمقراطية دابا”، وصفها بعض الثقات بالمفرقعات المبللة. كما علمت أنه بعد أن وظف اللعبي وعقيلته في شركة شمس بداية هذا القرن أو قبيلها مارس عليهما المحاسبة العسيرة ثم طردهما شر طردة.
ليس ما ألمعت إليه هو ما يهمني في هذا المقال، بل الضجة التي أثارتها مطالبة الرجل وأتباعه بتبني الدارجة المغربية في تعليمنا الأوّلي (ندوة 4-5 أكتوبر 2013) وما كان لها من توابع وزوابع ساهمتُ فيها قدر المستطاع، إذ نشرت في الموضوع خلال 2014 مقالة في Le Matin، أتبعتها بأخرى في موقعNewz.ma عنوانها”Pour en finir avec les ayouchiens et consorts”، وتعمدت كتابة المقالتين بالفرنسية عسى أن تفيدا عيوش وصحبه وتحملانهم على مراجعة دعوتهم والعدول عنها. ويظهر أن الإشهاري اطلع عليهما إذ أنه اعتذر عن المشاركة في ندوة حول الموضوع ذاته بقناة فرنسا24 ما إن علم بمشاركتي فيها، كما أخبرني بذلك صاحب البرنامج جمال بودومة.
عندما قبل عبد الله العروي محاورة عيوش في دعوته تلك بالقناة الثانية، فقد ارتكب خطأ وأيَّ خطأ إذ أن محاوره ليس من وزنه ولا طبقته ثقافيا وعلميا، ثم إن المقابلة كانت في آخر الأمر عديمة التأثير في مدير “شمس”، وإن كانت ذات جدوى لما أن كشفت عند هذا الشارم بل المشرمل عن ضعف بضاعته وهشاشة رؤياه (وفعل شرم، لعلم من لا يعلم، يعني لغةً صرمَ، شقَّ، فرم). وهو بالرغم من زلاته ما زال في غيّه وعناده مداوما مستميتا، وهذا ما حدا بي إلى إضافة هذه المقالة، سيما وأن الرجل أمسى -واعبثاه!- عضوا في التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي ما انفكَّ يجادل في فكرة إدراج الدارجة أو إلغائها، ويتوجه في هذه القضية وغيرها، حسبما قيل، إلى الفصل بضربة نرد (التصويت)، كأنما المغرب حديث العهد بالإستقلال أو ليس له قرون من تبنيه للغة العربية في التدريس والإنتاج القيّمِ والغزير بها.
*
في مغرب المغربات، نشهد مند مدة تكاثر الظواهر السلبية الضارة، منها على سبيل المثال الفساد السياسي والأخلاقي، توالد الخلايا الإرهابية، التشرميل والهولكانزم، إلخ. وهناك، أخرى ليست أقل ضررا، وهي المحدقة بنسيجنا اللغوي فالثقافي، قد أتاكم خبرها متمثلا في كون نفر اجتمعوا في تلكم الندوة التي حضر افتتاحها -واأسفاه!- شخصيات مرموقة)، وذلك ليشرِّعوا لوضعنا اللساني، ويفتوا بإدراج الدارجة في طور تعليمنا الأوّلي، مقدمين هذا الإجراء لحل مشاكل تعليمنا المستعصية (من هدر مدرسي وتدني مستوى التحصيل والانقطاع عن الدراسة من طرف خمسة ملايين تلميذ…). ولو توفر لهؤلاء الأدعياء نصيب من التكوين اللساني الرصين لكانوا بادروا قبل أي كلام إلى تجريب عرضهم على عينة مدرسية يختارونها (وتكون كوباي cobaye بلغة المخبريين)، وذلك حتى يتأكد لهم عيانا وبالملموس خوار دعوتهم وفسادها، وهذا اختصارا بيانه:
1- العامية المغربية التي لا اختصاص لأولئك القوم فيها، من ميزاتها الرئيسية أنها متغايرة محليا وجهويا بنسب ما، ومتحللة من أيِّ تقعيد أو تنظيم إجماعيين شموليين، كما تقضي طبيعتها الإختزالية الإدغامية والتواصلية عبر مثلا ما يسميه اللسانيون aphérèse (زاكورة بدل بنزاكورة ولا علم لصاحب الجمعية بهذا!) وapocope (بالتي عوض بالتي هي أحسن)، وتُعد في عامية كل اللغات بالمئات بل أكثر، وتندرج في ما يسمونه قانون الجهد الأدنى…
2- عاميتنا، ككل العاميات، لا يمكن لملمة شتاتها المتأصل، حتى ولو ضُبطت، في أي صنف معياري موحد، وبالتالي إحلالُها محل اللغة العربية الوسطى الحديثة، ناهيك عن ربطها التواصلي بالعاميات العربية الأخرى.
3- إن المقتدر على قراءة نص دارجي يسهل عليه أكثر قراءة أيّ نص بعربية ميسورة ولو لم تُشكل حروفها، وهذا ما يمكن تبيُّنه والبرهنة عليه عند التلامذة المبتدئين، إذ تمكنهم هاته من إدراك قرابتها العضوية بتلك، خصوصا في قاموسهما المشترك؛ أما الإبتداء بالدارجة ثم الإستئناف بالفصحى فهو مع أولئك المضلين كلام هراءٌ معوج وتخليط على المتلقين مُضلٌّ أهوج، يمنع عنهم ولوج نصوص العربية عبر تاريخها المديد.
4- تبعا للشرملات السابقة، تقوم أخرى شاخصة في جهل من نعنيهم بأعمال معجمية بالغة الإفادات حول المشترك اللفظي بين طبقتي الفصحى والعامية (عبد العزيز بنعبد الله، محمد الحلوي…). وهذا المشترك يستوجب عملا جماعيا أقنعني اشتغالي به منذ سنوات، ولو على نحو متقطع، أن تغطيته ما زالت بعيدة عن المبتغى والمراد، نظرا لوفرة المادة وتشعب تقاطعاتها وإحالاتها، وكلها تعرض بالدلائل والقرائن الملموسة أواصر القرابة والرتق الكثيرة بين الفصحى وعاميتها المشتقة منها. وذلك ما يجهله أولئك المشرملون.
5- الزلة الخامسة، ولست الأخيرة، تثوي في انعدام إعمال هؤلاء للمنهج المقارن الكاشف عن ثوابت وتماهيات لا مناص للباحث من رصدها وتمثلها. ولو أنهم فعلوا لسجلوا أن فرنسا، وهي قبلتهم ومرمى خدماتهم، لا يتحدث ناسها في حياتهم اليومية والأسرية لغة موليير وفولتير مثلا ومالارمي وسان-جون بيرس، أو أن ليست لهم لهجاتهم العامية ولغاتهم الإقليمية. فمن ذا الذي في فرنسا طالب يوما بإحلال عاميتها الدارجة محل لغتها الفصحى، ولو في التعليم الأوّلي؟ طبعا لا أحد، إذ أن “اللغة الأم”، كما تسمى تجاوزا، لا تهيئ الأطفال، على أكبر تقدير، إلا لفهم كلمات الأغاني السهلة والأحاجي المحلية دون اللغة المفاهيمية والمجازية المكتوبة المنظمة، التي يكون فضاؤها الطبيعي والوظيفي هو المدرسة.
تلكم عينة من الزلات المشرملة التي يمكن تعزيزها بأخرى كثيرة، وكلها لا تخطر ببال الدارجيين المزيفين، وذلك لأن الأجندا عندهم تصدهم عنها وتعميهم. إنها أجندا رئيس جمعية زاكوره وأزلامه النكرات، لا يعنيهم البتة تنمية الدارجة أو ترسيخها في منظومتنا التعليمية، بل إن مقصدهم هو الإنتهاء إلى تمزيق المغرب لغويا فثقافيا أي قددا وعصائب من اللغات واللهاجت، حتى يتم ربطه مدى الحياة بحِجر منطقة النفوذ المسمىاة بالفرنكوفونية. وهكذا انفضحت لعبة الرجل أكثر، إذ أخذ في المجلس المذكور يناضل مع آخرين من أجل الحفاظ على موقع الفرنسية السيادي في التعليم، وذلك ضدا على أعضاء يتقدمهم د. أحمد العبادي، يسعون إلى جعل اللغة الأنجليزية تتبوأ المكانة الأولى كلغة أجنبية لأسباب عملية وتنموية نعرفها. أما من زاوية أولئك فالأجندا تبقى هي هي، لا تغيير فيها ولا تعديل: تضخم التنوع يقتل التنوع، وبالتالي كل السبل اللسانية (الكتابية والشفهية) يلزم في آخر المطاف أن تفضي إلى لغة فيدرالية جامعة تكون بمنطق الحاجة إلى الوحدة هي الفرنسية. وهذا ما يتغياه “العيوشيون” وينشدونه، وذلك بتقرير نهاية العربية الموصوفة عندهم بالكلاسيكية (وهو نعت دخيل على معجمها) ثم استبدالها، ولو تدريجيا، بالدارجة التي هي عندهم بمثابة حصان طراودة أو قميص عثمان لا غير، يلتقي معهم حول ذلك في الأمس القريب المارشال ليوطي بدورياته الآمرة باستئصال العربية ومحوها (أشهرها دورية 16 يونيو 1921)، وكذلك لوي برونو في كتابه “مدخل إلى العربية المغربية” ادعى فيه عن جهل أن العامية المغربية مستقلة عن العربية الفصحى بقدر استقلال اللغة الإيطالية الحديثة عن لاتينية شيشرون؛ أما في أيامنا فإن من المتعاونين الأجانب على إنجاز تلك الأجاندا فهم الباحث بول ڤرمرين والناشطة الأمريكية إ. برنديس والدارسة اللهجاتية د. كوبي، وغيرهم من المتهافتين عديمي المعرفة والخبرة. وحملات هؤلاء آخذة منذ مدة في إحداث آثار ومضاعفات سلبية تتشخص في اكتساح الحرف اللاتيني، كما نشاهده بأم أعيننا، للفضاءات المدينية من محلات تجارية أو ترفيهية وغيرها (وقد فات أن كتبت باللغتين في الموضوع)؛ هذا من جهة، ومن أخرى شرعنا نسمع وصلات ونرى ألواحا إشهارية بدارجة فجة لقيطة تمتزج بها كلمات شوهاء بالفرنسية، وتبعد أيما ابتعاد عن جمالية عاميتنا المغربية التي نعشقها في الأزجال والملحون والموشحات، ونرددها صافيةً، معبّرةً، بديعة، كما ننتعش بها ونزهو في تحف كبار المغنيين مشرقا ومغربا، وكذلك في المسرح والسينما وفي حوارات معظم الروائيين العرب، وكاتب هذا المقال منهم. وللأسف، هذا ما لم ينتبه إليه كثير من الغاضبين أو المتهكمين على الإشهاري، إذ رموا دعوته ومعها العامية نفسها، في حين أن الأحق والأصوب هو في تبرئة ساحة هاته من لغو الأدعياء المتنطعين والدخلاء المتسلطين، مع التأكيد على أن ترقية الفصيح والعامي يُعوّل عليها أيضا لترقية المجتمع وذائقته اللغوية والفنية…








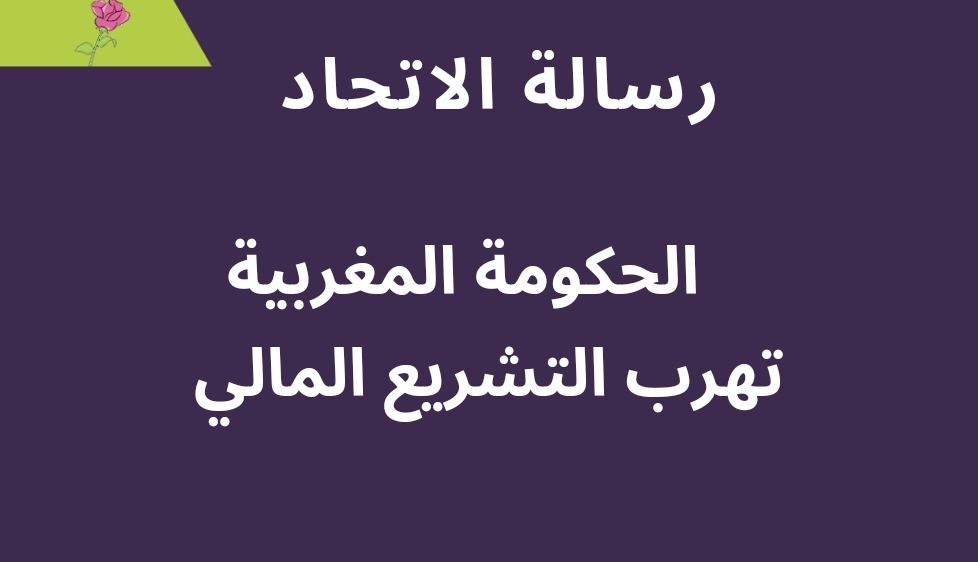
تعليقات الزوار ( 0 )