من المؤسف جدا أن يعتبر البعض التشويش (بل والبلطجة، أحيانا) عملا “نضاليا”؛ ومن المخزي أن يستقوي البعض على حزبه بالصحافة المشبوهة لترويج الإشاعة وتسميم الأجواء وتصفية الحسابات؛ ومن غير المفهوم، سياسيا وأخلاقيا، أن يصبح العداء للأشخاص (لأسباب قد تكون تاريخية وموضوعية وقد تكون فقط نفسية وسيكولوجية) محركا لأناس يجرون وراءهم تاريخا نضاليا حافلا (ولا أقصد هنا من لم تعد لهم أية مصداقية، بل أقصد أولائك الذين تبقى مكانتهم محفوظة، مهما كان الاختلاف معهم)، فيمنعهم ذلك من التمييز بين الشخص والمؤسسة ويسلب منهم القدرة على إدراك ما يلحقونه من أضرار بالغة ليس بحزبهم فقط، بل وبتاريخهم النضالي الشخصي؛ ومن المحبط حقا أن تكون الديمقراطية لا تعني للبعض سوى الانتصار والفوز وتحقيق الذات، وإلا أصبحت مغشوشة ومخدومة، إلى غير ذلك من التهم الجاهزة…
شخصيا، يؤلمني ما أقرأه وما أسمعه عن بعض التحركات وعن بعض التجاوزات التنظيمية هنا وهناك، التي تسيء إلى الاتحاد الاشتراكي وإلى تاريخه النضالي. فأنا (والعياذ بالله من الأنا) منخرط قلبا وقالبا في حزب القوات الشعبية منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي. وقد عشت معه وفيه، منذ ذلك التاريخ، كل اللحظات النضالية الجميلة وكل الفترات العصيبة، انطلاقا من ميلاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، مرورا بالإضرابات القطاعية سنة 1979، فالإضراب العام ليونيو 1981، فأحداث ماي 1983، ثم الانتخابات المحلية في نفس السنة، والتشريعية سنة 1984؛ وقد عرفت البلاد والحزب معا، بعد ذلك، أحداثا سياسية واجتماعية هامة، نذكر من بينها الإضراب العام لدجنبر 1990، ثم المعارك الانتخابية لسنوات 1993 و1997، وصولا إلى المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الاشتراكي سنة 2001 وما تلا ذلك من أحدث، لا داعي لسردها. وهي كلها محطات وأحداث بصمت، بطريقة أو بأخرى، ليس تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقط، بل التاريخ السياسي للمغرب الحديث.
وقد كان لي شرف الحضور في مؤتمرات الحزب من الرابع (1984) إلى التاسع (2012)، باستثناء المؤتمر الوطني السادس لأسباب لا يتسع المجال للخوض فيها. لكن نشاطي الأساسي كان، إلى حدود مطلع التسعينيات، في مجال العمل النقابي. لقد تحملت مسؤوليات وطنية ومحلية في الك.د.ش وبعد ذلك في النقابة الوطنية للتعليم العالي. لكني لم أتهرب يوما من المسؤولية الحزبية. وأؤكد، هنا، أنني لم أكن أسعى إلى المسؤوليات (سواء في النقابة أو الحزب؛ وهذا ما يعرفه الأصدقاء والإخوة جيدا). فأغلب ما تحملت منها، كان برغبة وبضغط من الأصدقاء المناضلين. ولا أتذكر أني اعتبرت نفسي، يوما، من أنصار أو أتباع فلان أو عَلاَّن. لقد كنت دائما من أنصار المشروعية. ولي، في هذا الباب، مواقف (على الصعيد المحلي) أغضبت مني أصدقائي؛ لكني لم أفقد يوما احترامهم.
وبمناسبة التحضير للمؤتمرين الوطنيين الأخيرين(الثامن والتاسع)، وباعتباري عضوا في المجلس الوطني للحزب بالصفة (كتب إقليمي)، فقد انخرطت بما يكفي من الحماس في إحدى اللجان الفرعية، ألا وهي لجنة “تفعيل الأداة الحزبية”. لقد اخترت الاشتغال في هذه اللجنة، من جهة، لقناعتي بأهمية الأداة في تصريف القرارات وخوض المعارك السياسية؛ ومن جهة أخرى، لكون الوضع التنظيمي كان يتسم بالتفكك والجمود والشلل على جميع المستويات؛ وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية، لا يتسع المجال لتناولها هنا.
بعد المؤتمر الوطني الثامن، رفع الأخ “عبد الواحد الراضي” شعار إعادة البناء؛ وهو اعتراف ضمني وصريح، في نفس الآن، بما آلت إليه الأوضاع التنظيمية من ترد ومن تفكك. لكن المشاكل الداخلية للحزب لم تزد إلا استفحالا بسبب الأنانيات المفرطة وبسبب التطاحنات بين الأشخاص والمجموعات وبسبب التسيب والفوضى التنظيمية؛ مما جعله، في أحد اجتماعات المجلس الوطني، قبيل الشروع في تحضير المؤتمر الوطني التاسع، يدق ناقوس الخطر ويطلق صرخته المدوية، معلنا أننا نسير نحو انتحار جماعي. وستبقى حيطان المقر المركزي بالرباط ترجع صدا هذه الصرخة وتدوِّي في آذان الحاضرين.
وحين تأتي مثل هذه الصرخة من رجل مثل “عبد الواحد الراضي”، المعروف بهدوئه وصبره وتحمله، والمشهور بحنكته السياسية وخبرته العلمية وقدرته التواصلية، فذلك معناه أن الأمر لم يعد محتملا وأن معاول الهدم قد تجاوزت كل الحدود وأن الذاتي قد طغى واستحكم في المواقف والسلوكات. وبمعنى آخر، فقد بلغ السيل الزبى.
في هذه الأجواء، تم الشروع في التحضير للمؤتمر الوطني التاسع. وقد بذلت كل اللجان الفرعية مجهودات مشكورة لينعقد المؤتمر في تاريخه المحدد وفي شروط حسنة. وكعادة الاتحاد، ورغما عن المشاكل الحقيقية والمصطنعة، فقد أبدع في التحضير وحقق إنجازا غير مسبوق في هذا المجال، تستحق عليه اللجنة التي سهرت على ذلك كل التنويه والتقدير والاحترام. فلأول مرة في تاريخ المؤتمرات الحزبية، يخاطب المتنافسون (الأربعة) على الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المواطنين من خلال برنامج تليفزيوني معروف؛ الشيء الذي أتاح لكل مرشح إمكانية بسط برنامجه (بالصوت والصورة وفي تفاعل مع أسئلة منشط البرنامج) وتقديم تصوره ومشروعه السياسي والمجتمعي والتنظيمي الذي على أساسه سيتعاقد مع المؤتمرين. وقد كانت الأزمة التنظيمية حاضرة بقوة في برامج المرشحين للكتابة الأولى.
لا أعتقد أنني سأجانب الصواب إذا ما قلت بأن مفاجأة المؤتمر الوطني التاسع بامتياز، هي مرور الأخوين “إدريس لشكر” و”أحمد الزيدي” معا إلى الدور الثاني. فهذا السيناريو، حتى وإن تم تصوره من قبل البعض، ما كان ليحظى بأي اهتمام. ولا أعتقد أن هناك مناضلا يستحق هذه الصفة، لم تفاجئه هذه النتيجة. فأن يتم إقصاء قيادي من حجم “فتح الله والعلو” في الدور الأول، أمر قد لا يكون دار بخلد كثير من المناضلين، بل أرجح أن لا يكون قد تصوره أحد.
ابتهج الفائزان بالدور الأول. تصافحا؛ رفعا شارة النصر. أخذت لهما صور تؤرخ للحدث. ومررنا للدور الثاني. وهنا، أيضا، أجزم بأن الاتحاديين الحقيقيين، كانوا يدركون لمن ستؤول مسؤولية قيادة الاتحاد الاشتراكي. فنتيجة الدور الأول كانت حاسمة، إذ حسابيا ومنطقيا، تبدو المسألة في غاية الوضوح والبساطة: فإلى جانب الفارق المهم، حتى لا أقول الكبير (أكثر من 100 صوت)، في الأصوات بين المتنافسين، خلال الدور الأول، كان هناك اتفاق مسبق بين “لشكر” و”المالكي” على أن يدعم المقصي منهما في الدور الأول الفائز لخوض غمار الدور الثاني. بمعنى أن الأصوات التي حصل عليها “الحبيب المالكي”، سيئول أغلبها، على الأقل، لصالح “إدريس لشكر”. وإذا أضفنا إلى هذا أن الأخ “فتح الله والعلو” لم يعط أي توجه لأنصاره للتصويت لصالح هذا أو ذاك؛ مما جعل المصوتين على “فتح الله والعلو” أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الامتناع عن التصويت (شخصيا لا أملك الإحصائيات لمعرفة التوجه العام لأنصار “والعلو”)، وإما التصويت بحرية وحسب القناعة الشخصية. وإذا علمنا أن هناك عددا من المؤتمرين الذين صوتوا لصالح “أحمد الزيدي” في الدور الأول، قد غيروا رأيهم في الدور الثاني، إما تحت تأثير المفاجأة أو بسبب بعض السلوكات لأشخاص محسوبين على “الزيدي”، فإن فرضية اختيار أنصار “والعلو” التصويت لصالح “لشكر”، هي الأرجح؛ وذلك لأسباب لا تخفى على لبيب.
لقد كانت اللحظة (لحظة المؤتمر) تقتضي بعث إشارات قوية للأصدقاء وللخصوم معا، مفادها نجاح الرهان التنظيمي بتكريسه للشرعية الديمقراطية وللتعددية الفكرية في إطار الوحدة. وكان ذلك سيكون عنصر قوة، يبعث الحماس في الاتحاديين ويجعلهم ينخرطون في إعادة بناء حزبهم وتقوية مؤسساته. فلو كان الأخ “الزيدي” سيد موقفه ومستوعبا للقفزة النوعية التي سجلها المؤتمر ومدركا للحظة الديمقراطية ولأهميتها، لبادر، كما يقع في كل الدول الديمقراطية وأحزابها، إلى تهنئة منافسه بالفوز، اعتبارا للمعطيات التي أوردناها في الفقرة السابقة.
لكن ما وقع، هو العكس تماما. فإلى جانب التصريحات التي أدلى بها البعض للصحف المشبوهة (التي ألفت الاصطياد في الماء العكر وبنت بعضا من “مجدها” على حساب الاتحاد الاشتراكي بالتحامل عليه وعلى قيادته وأطره، وذلك بسلوك طريق الكذب الصراح والإشاعة المقيتة)، يدعي فيها أصحابها التدخل الخارجي في مسار المؤتمر، تم الاجتهاد في تبخيس نتائج هذا المؤتمر، مرة بالرفض ومرة بالتشكيك وأخرى باختلاق أحداث، كذبها الواقع وكذبها البعض ممن نسبت إليهم وكذبتها الممارسات. وقد عبرت عن مواقفي من هذا الموضوع مباشرة بعد المؤتمر وبدون مواربة، في مقالات أغضبت البعض ممن يرفضون الحقائق الناصعة.
وشخصيا، لا يهمني من غضب أو من ابتهج مما عبرت عنه من مواقف، أنا مقتنع بها؛ فالأشخاص لا يهمونني، بقدر ما يهمني الحزب ومؤسساته. وليست لي حسابات أصفيها مع أحد، إلا حساب واحد أتشبث به وأدافع عنه بما استطعت: يتعلق الأمر بسمعة الاتحاد ومكانته في المشهد السياسي. وإيماني بالمؤسسات الحزبية يجعلني أشرس ما أكون حين يتم المساس بها. فإذا كان حزبنا ينادي بدولة المؤسسات، فالأولى به أن يكرس هذا المبدأ داخل صفوفه ويعمل على احترامه. فلا معنى لمطالبة الغير بتطبيق القانون ونكون نحن أول من يعطي المثال الأسوأ في هذا الباب. ولا معنى لمطالبة الحكومة بتفعيل الدستور، إذا كنا نحن عاجزين عن تفعيل القوانين والأنظمة التي نتفق عليها في مؤتمراتنا. ثم ما معنى أن نتفق في المؤتمر على شيء، ثم نتعسف على قراراتنا ونريد تغييرها حسب الهوى وحسب الرغبات الذاتية، وليس بناء على معطيات ومستجدات مقنعة.
فلو نظرنا في مسألة التيارات، مثلا، سنجد أن الطرح الحالي لا يسنده لا الواقع ولا التحليل و لا الوضع التنظيمي. شخصيا، ليس لي أي موقف من التيار، ولست مؤهلا لا سياسيا ولا فكريا للخوض فيه. لكن ما أفهمه من كلمة تيار، هو تعبير عن توجه فكري وسياسي، يختلف عن التوجه الفكري والسياسي السائد داخل نفس التنظيم (أي نفس الحزب)، مما يجعل منه قوة فكرية يدعمها تصور سياسي واضح، يقدم نفسه بديلا عن تصور القيادة. وبمعنى آخر، فالتيار يكون فكريا وليس تنظيميا، وإلا أصبح هناك حزب داخل حزب. وهذا ليس مقبولا لا سياسيا ولا تنظيميا ولا أخلاقيا.ويبدو أن ما أصبح يعرف بـ”تيار الديمقراطية والانفتاح” داخل الاتحاد الاشتراكي، يعاني من فقر فكري كبير؛ ذلك أنه، حسب علمي المتواضع، لم ينتج إلى حد الآن أية أرضية فكرية وسياسية تستحق الذكر، تُقعِّد للتيار وتؤسس له. كل ما هناك كلام عام وشعارات وحديث عن تنظيم التيار أفقيا وعموديا.
ثم إن التناقض الخطير الذي يقع فيه متزعمو التيار، هو، بالأساس، تشخيصهم للصراع. فالصراع هو مع “إدريس لشكر” كشخص وليس كمؤسسة من مؤسسات الحزب. فهم يعادون “لشكر” ويعبرون عن ذلك صراحة. ومع ذلك، يريدون منه أن يقبل بوجود التيارات داخل الحزب، في حين أن المؤتمر رفض ذلك. فما هذا التناقض؟ وما هذا العبث؟ لماذا لم يدافع من يعتبرون أنفسهم اليوم تيارا على هذا الخيار داخل المؤتمر؟ هل لأنهم كانوا يتوقعون، فيما يخص القيادة، نتائج غير تلك التي أفضى إليها المؤتمر؟ وبأي حق يطلبون من”لشكر” القبول بوجود التيارات؟ وهل لـ”إدريس لشكر” الحق في أن يقبل بذلك؟ أليس مطوقا بقرارات المؤتمر؟ هل طرح “الزيدي” في برنامجه الانتخابي مسألة التيارات؟ وهل التزم “لشكر” في برنامجه بالعمل على شرعنة التيارات؟ … إن “لشكر” ومن معه في قيادة الاتحاد مطالبون بتنفيذ مقررات المؤتمر وليس شيئا آخر، وسيحاسبون على ذلك في المؤتمر المقبل.
لن يختلف اثنان في أن التحركات التي يقوم بها ما يسمى بتيار الديمقراطية والانفتاح، لن تخدم إلا خصوم الحزب، لأن الصورة التي تعطى عن الحزب لا تخرج عن صورة التشرذم والتناحر والصراع على المواقع، الخ. لا يعقل أن نخرج من مؤتمر، بما له وما عليه، لكنه سجل، بكل تأكيد، تكريس الشرعية الديمقراطية داخل الاتحاد، لننهمك في توجيه السهام المسمومة في اتجاه المؤسسات الحزبية المنبثقة عن المؤتمر. لقد أصبحنا، بهذه الطريقة، نحول النجاح إلى فشل والفشل إلى نجاح. فهل إلى هذا الحد استطاع العداء للأشخاص (وأساسا إلى شخص الكاتب الأول) أن يحجب عن المعنيين بالأمر مدى الضرر الذي يلحقونه بحزبهم، فيصدق في حقهم قوله تعالى: “فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ”؟ أم أن هناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله والراسخون في تغذية التشويش على الاتحاد الاشتراكي؟
شخصيا، معرفتي بالأشخاص (بمن فيهم الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي وقادة ما يسمى بالتيار) سطحية جدا؛ ولا أشعر بأي نقص من هذه الناحية؛ فالأشخاص لا يهمونني، بقدر ما تهمني مواقفهم وأفعالهم. وفي هذا الصدد، لا يمكنني إلا أن أسجل الدينامية الكبيرة التي خلقتها القيادة الجديدة ليس فقط داخل الحزب، بل وأيضا في المشهد السياسي المغربي.
لا أعتقد أن الدبلوماسية الحزبية كانت، في وقت من الأوقات، أنشط وأفيد للقضية الوطنية مما هي عليه الآن (أتحدث، هنا، عن الدبلوماسية الحزبية، وليس عن الدبلوماسية الرسمية التي مارسها الاتحاد من موقع المسؤولية، خاصة في عهد المجاهد “عبد الرحمان اليوسفي”). ويطول الحديث عن المنجزات المهمة في هذا المجال وفي زمن قياسي(وقد سبق لي أن سجلت بعضا من ذلك في مقال بعنوان “من دواعي الفخر والاعتزاز بالانتماء للاتحاد الاشتراكي”). داخليا، الأنشطة الإشعاعية الكبيرة (5 أكتوبر 2013: “ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي” بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط؛ و29 أكتوبر 2013: تخليد يوم الوفاء لشهداء الاتحاد بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء) التي نظمتها القيادة الجديدة (وقاطعها أصحاب التيار إلا من رحم ربك) أعادت للمناضلين الثقة في حزبهم. وتنظيميا، يسهر المكتب السياسي بجدية على تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية المرتبطة بهيكلة الفروع وعقد المؤتمرات الإقليمية والجهوية والمؤتمرات القطاعية، سواء الموازية منها أو المهنية، الخ. فهل يريد أصحاب التيار إيقاف هذه الدينامية ليستمر الجمود والشلل والانتظارية المقيتة؟ أم ما ذا يريدون؟… ما الهدف من التشويش على هذه الدينامية؟ ومن المستفيد منها؟ وما هي الدوافع الحقيقية؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المقلقة…
لقد أبان الاجتماع الأخير (فاتح مارس 2014) لكتاب الجهات والأقاليم التوجه السائد داخل الحزب. فبعد تثمين الدينامية الجديدة داخل الاتحاد، كان المطالبة والتأكيد على ضرورة تحصين الحزب بالصرامة الديمقراطية المطلوبة وبتطبيق القانون وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي للحزب. كما تم التعبير عن الاستياء من تطاول بعض المتنطعين الذين وصل بهم الأمر إلى اعتبار أنفسهم ضمير الاتحاد. مما يعتبر قمة في الغرور وقمة في عدم المسؤولية وقمة في التنكر للقيم الديمقراطية.
خلاصة القول، من يفكر في الحزب وينسى ذاته (سواء كانت مريضة أو منتفخة أو متواضعة)، لا يمكن إلا أن يشجع كل المبادرات الإيجابية (وأستحضر، هنا، مثالا شعبيا متداولا بمكناس، يقول: “لِّي تزوَّج مِّي نقولو عْزيزي”) . بالطبع، نحن لسنا من بني ” oui, oui ولا نقدم شيكا على بياض لأحد. فالاتحاد معروف بنقاشاته الحادة والمرطونية، لكن داخل المؤسسات الحزبية، وليس عبر المنابر المشبوهة أو عبر تنظيمات موازية فوضوية. داخل الاتحاد، لا شيء يعلو على النقاش؛ ولا يمكن لأحد أن يدعي بأنه محروم من التعبير عن رأيه؛ لكن الاتحاد يرفض الابتزاز ويرفض ديكتاتورية الأقلية. فالأقلية (أو المعارضة) لها كل الحقوق، لكن عليها أيضا واجبات. وهنا مربط الفرس. فالناس يريدون حقوقا ويتنكرون لواجباتهم. وهذا مخالف للأعراف الديمقراطية ولأبجدية العمل السياسي ولأبسط قوانين التعايش داخل أي تجمع بشري. ثم إذا كنا قد تمنينا النجاح لحكومة بنكيران، لأننا نرى في نجاحها خير للبلاد كلها، وفي فشلها ضرر للبلاد كلها، فلماذا لا نتمنى للقيادة الجديدة للاتحاد النجاح في إعادة بناء الحزب وفي استعادة المبادرة، لأن في ذلك نجاح للاتحاديات والاتحاديين كلهم؟ أم هي عقلية: إذا متُّ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ !!؟ أو “أنا ومن بعدي الطوفان!”؟








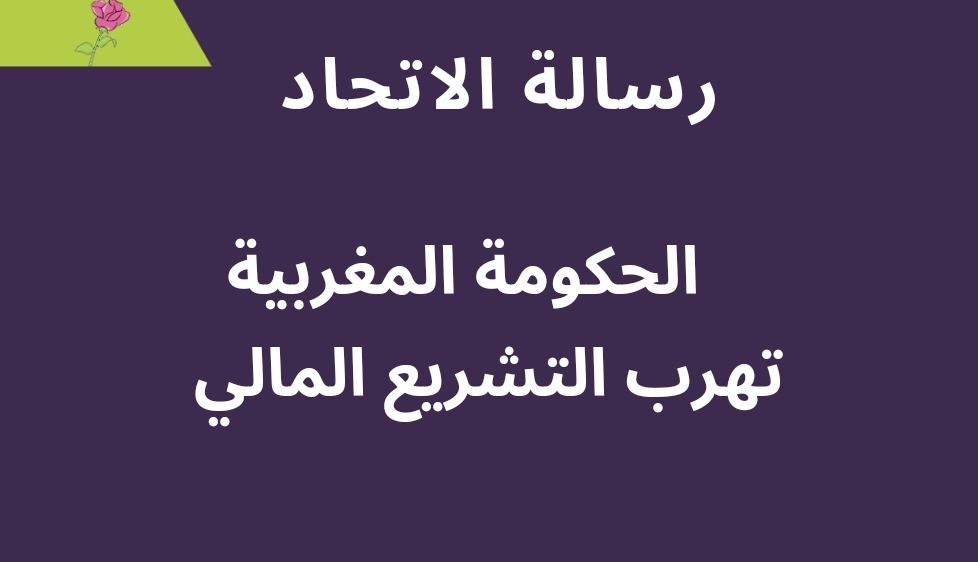
تعليقات الزوار ( 0 )