محمد إنفي
كمواطن مغربي وفاعل سياسي، لا يمكن لي إلا أن أصفق لما جاء في الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» (عدد يوم السبت 31 يوليوز/الأحد 1 غشت 2021) مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من كون هذه الأخيرة وقضاتها سيقفون «في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية».
لكن بقدر ما أنا مسرور بموقف رئاسة النيابة العامة وقرارها، بقدر ما أنا متوجس من حيل سماسرة الانتخابات وممارسات مفسدي الاستشارات الشعبية؛ تلك الحيل والممارسات التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل جديد، سواء أكان هذا الجديد تنظيميا أو قانونيا أو سياسيا، حيث يجتهد المفسدون في البحث عن أساليب جديدة قمينة بتضليل كل مراقبة محتملة، سواء كانت هذه المراقبة من طرف أجهزة رسمية (المراقبة القضائية، على سبيل المثال) أو من طرف منظمات مدنية (جمعيات حقوق الإنسان كمثال) أو غيرها من وسائل المراقبة.
وكما يقول المثل المغربي: «للِّي عضُّو الحنْشْ من الْحْبَلْ إِخافْ» («من لدغه ثعبان، من الحبل يخاف»)، وكثيرا ما لدغت تجربتَنا الديمقراطية الفتية ثعابينُ على مر الاستشارات الشعبية! لقد سمعنا، في مناسبات عدة، خطابا رسميا يبعث على الاطمئنان ويُبشِّر بنظافة العملية الانتخابية؛ لكن المفسدين يقولون كلمتهم دائما؛ ذلك أن لهم أساليبهم الخاصة التي تُصعِّب مهمة المراقبين، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الرسمية أو المراقبة الحزبية؛ والمخزي في الأمر أن ممثلي بعض الأحزاب الذين يلقون خطابات وردية في الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، يعرفون أن بعض مرشحي أحزابهم لهم باع طويل في الفساد والإفساد الانتخابي الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن للمتشبعين بالمبادئ الديمقراطية إلا أن يشعروا بنوع من العجز في مواجهة آفة الفساد الانتخابي، سواء المتمثل في الرشوة الانتخابية، أو المتمثل في استغلال النفوذ (بعض رجال وأعوان السلطة، مثلا، قد يُدعِّمون هذا أو ذاك، سرا أو علنا، على حساب باقي المرشحين لأسباب قد لا يغيب بعضها عن الأذهان)؛ ومهما حاول المراقبون العاديون ومهما اجتهدوا في مراقبة المفسدين، فلن يستطيعوا كشف ألاعيبهم؛ وما لم يتدخل جهاز الشرطة القضائية بشكل تلقائي واستباقي من أجل حماية نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، فلن تسلم هذه الانتخابات من الإفساد.
ذلك أن المراقبة العادية، حسب رأيي المتواضع، لن تجدي نفعا في كبح جماح المفسدين؛ فلا اللجان الوطنية ولا الجهوية ولا الإقليمية قادرة على كشف ألاعيبهم التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل وضع. فجريمة الرشوة الانتخابية لها أوجه متعددة وتتلون كالحرباء؛ إذ، في الشرط الحالي، يمكن الاستغناء عن الرشوة التي كانت تقدم «بالعلالي» يوم التصويت، والاكتفاء بالرشوة القبلية بالاعتماد على سماسرة متمرسين، تقدم لهم مبالغ مالية هامة، وقد تكون خيالية حسب الوضع المادي للراشي ورهانه؛ ويتكلف السمسار (أو السماسرة حسب الحالة) بشراء الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو الحي السكني أو الدوار أو غيره؛ وقد يقوم بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية؛ بل وحتى قبل انطلاق عملية الترشيح؛ ودليلي في ذلك ما يقع على مستوى الجماعات القروية، حسب ما يصل إلى سمعي، من تخلي بعض المترشحين عن ترشيحهم مع حزب ما والانتقال إلى حزب آخر، إما بسبب الإغراء المادي أو التهديد أو التخويف؛ إذ يخشى بعض المترشحين على دوائرهم من الانتقام، سواء في حالة الفوز أو في حالة الخسران؛ وذلك، بحرمانها من خدمات الجماعة (الطرق، النقل، الماء والكهرباء، إلخ…)، إذا لم يرضخوا لإرادة «الإمبراطور» المتحكم في الجماعة.
ويكفي أن أشير إلى أن بعض الأصناف المهنية (الفلاحة كمثال) لم تسلم من هذه الألاعيب والممارسات التي أثرت بشكل سلبي على الترشيحات في الانتخابات الجماعية (ولي أمثلة ملموسة على ذلك)، رغم أن انتخابات يوم 6 غشت مرت في جو عادي.
إن بلادنا مقبلة على انتخابات نوعية ومصيرية؛ فلأول مرة، سيصوت المغاربة، في يوم واحد (8 شتنبر 2021)، على ممثليهم في الجماعات الترابية (مجالس الجماعات ومجالس الجهات) وممثليهم في مجلس النواب (المجلس التشريعي)؛ إنها انتخابات برهان ديمقراطي كبير، وفي سياق وطني وإقليمي ودولي خاص يتميز، من جهة، بجائحة كورونا وأضرارها المدمرة، اقتصاديا واجتماعيا؛ ومن جهة أخرى، فإن بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تخوض معارك على عدة واجهات؛ من القضية الوطنية الأولى (الوحدة الترابية)، إلى التغطية الصحية والاجتماعية، إلى النموذج التنموي الجديد المحتاج إلى نخبة قوية قادرة على تفعيله بشكل أمثل، مرورا بمواجهة دسائس بعض الدول الأوروبية (بسياسييها وإعلامها) التي تسعى إلى النيل من بلادنا ومؤسساتها، وغيرها من المعارك السيادية؛ لذلك، فإن بلادنا محتاجة إلى مؤسسات تمثيلية قوية؛ مما يجعل حماية هذه المؤسسات من الإفساد من أوجب الواجبات وأولى الأولويات، حتى لا تتعرض للإضعاف بفعل الفساد والإفساد.
لقد سبق لي أن أثرت موضوع الغش في مقال بعنوان «في محاربة الغش وقاية وحماية للدولة والمجتمع وخدمة للمصالح العليا للوطن» («العمق المغربي» بتاريخ 24 يوليوز 2021). والغش، في ديننا الحنيف، من الكبائر كما نعلم؛ لكنه، للأسف، قد استشرى في مجتمعنا بشكل تطبَّع معه الناس، وأصبح في حكم السلوك العادي لدى البعض، سواء في التجارة أو الإدارة أو الامتحانات أو المعاملات بمختلف أصنافها.
وأعتبر الغش الانتخابي من أكبر الكبائر لأنه يُضعف المناعة الديمقراطية لبلادنا، وينتج مؤسسات تمثيلية هشة لا تخدم مصلحة المواطن ولا تساهم في تمنيع بنائنا الديمقراطي، لكون «نخبها» لا تضع نصب عينيها مصلحة الوطن، بل لا تهتم إلا بالمصلحة الشخصية الضيقة.
خلاصة القول، محاربة الرشوة الانتخابية (الغش الانتخابي) تحتاج إلى جهاز مراقبة قوي يعتمد أساليب خاصة لكشف المتلاعبين لإعطاء المثال بهم من أجل ردع المفسدين الفعليين والمحتملين. فالأجهزة التي تفكك خلايا الإرهاب والتهريب، لن تعدم عناصر قادرة على كشف خلايا الفساد الانتخابي؛ خاصة وأن بعض أباطرة هذا الفساد يشار إليهم بالبنان في بعض المناطق، لكن المراقبة العادية لن تصل أبدا إلى الدليل المادي بشأنهم، مهما اجتهدت.










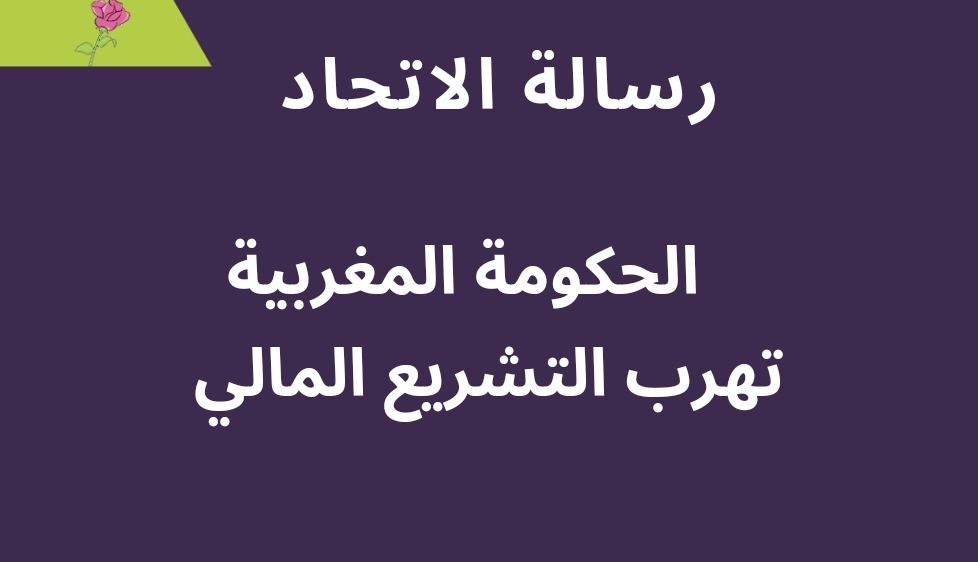
تعليقات الزوار ( 0 )