من الواضح أن ما وٓردٓ في الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش، حول الأحزاب السياسية، قد أثار ردود فعل قوية من طرف فئات واسعة من الرأي العام، أغلبها عٓبّرَ عن تجاوبه مع مضامين النقد التي وجهها للممارسة الحزبية، رغم أنه ثٓمّنٓ وجود استثناءات من الفعاليات النزيهة والشريفة، داخل الأحزاب.
غير أَن التوجه العام للخطاب، تٓمٓيّزٓ بالنقد الحاد للممارسة الحزبية، وهذا ما يلقي على عاتق الفاعلين السياسيين، وخاصة من القيادات، مسؤوليات جسيمة، لمراجعة هذه الممارسة، لأن هناك مؤاخذات جدية، من طرف أعلى سلطة في الدولة، ولأن فئات واسعة من الشعب، تتجاوب معها، انطلاقًا من تجربتها المعيشة.
فما هي هذه المؤاخذات؟إنها مجمل الأمراض التي أصابت الفعل السياسي، على امتداد سنوات، وتراكمت وتضخمت وتحولت إلى سرطان، ينخر أجسام الأحزاب، بتفاوت في حدة الإصابة. غير أن هناك قواسم مشتركة جعلت صورة «السياسي» يطغى عليها طابع السلبية.
يمكن القول إن هذا الانطباع السائد في المجتمع، مبالغ فيه، ويتعامل بمنهجية المطلق، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تخضع الأحكام للنسبية وللسياقات والظروف الخاصة، بكل حزب وكل تجربة. لكن هذا لا يعفي القيادات الحزبية، من مراجعة أوضاع أحزابها، لأن هناك نفوراً متزايداً منها.
قد تكون النيات حسنة لدى أغلبية الفاعلين السياسيين، غير أن هناك ممارسات قد تصدر من الأقلية الحزبية، لكنها تسيء لصورة الحزب كله، مثل التسابق نحو الريع، والفساد والزبونية والمحسوبية، والانتهازية، والتقلب في المواقع، والتملص من الالتزامات، والمزايدات في المواقف، وغيرها من مظاهر اللامسؤولية، التي انتقدها الخطاب الملكي، بقوة.
قد تكون هناك أسباب متعددة لما وصلنا إليه، تتقاسم المسؤولية فيه الدولة والأحزاب والمجتمع، هذا صحيح، لكنه لا يمكن أن يشكل مبرراً للتخلي عن المراجعة، لأن دور الفاعل السياسي، هو الإنصات للواقع والتعامل معه من أجل تغييره، بمنطق النقد الذاتي والمصلحة العامة.
وحتى لا نخطئ في التحليل، فإن ما يحصل في المغرب، حصل في بلدان أخرى، عريقة في الديمقراطية، حيث حصلت هزات كبيرة، عصفت بالتنظيمات «التقليدية»، لأن المجتمع كان تواقاً لتخليق الممارسة السياسية والحياة العامة. ربما البدائل التي قدمت، ليست هي الملائمة، لكن هناك حاجة مجتمعية للتغيير، لأن العالم يتغير.
الكاتب : يونس مجاهد









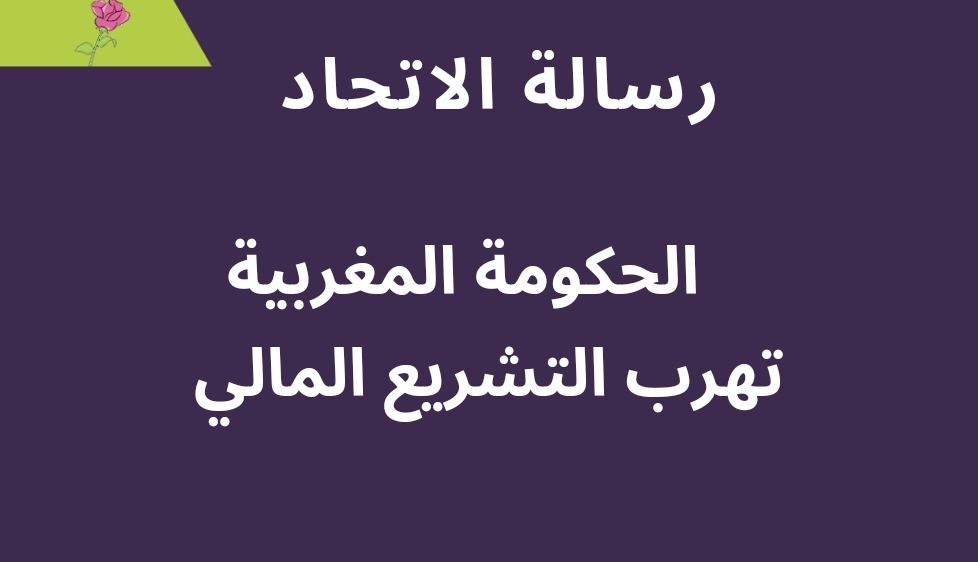
تعليقات الزوار ( 0 )